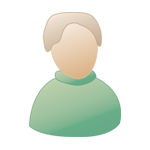|
الواجب اتجاه اللاجئين
نصرة أم مخيمات أم طرد؟؟؟
قضية اللاجئين وبالذات المسلمين هذه الأيام قضية كبيرة وبارزة إعلاميا، واغلب اللاجئين إن لم يكن جلهم من المسلمين، وسبب كونهم لاجئين هو تعرضهم للقمع والقتل والقهر والذل والهوان في بلادهم وذلك بسبب غياب الخلافة الإسلامية، مما يضطرهم لترك بلادهم والبحث عن بلاد أخرى تكون أكثر أمانا من بلادهم.
فمن اللاجئين الفلسطينيين واللاجئين السوريين حاليا والبورميين والليبيين وغيرهم، وأمام هذا الأمر لا نجد أي تصرف من حكام المسلمين الحاليين اتجاههم إلا أحد أمرين:
الأول: استضافتهم في مخيمات لا تقي حرا ولا بردا، وليس فيها ابسط مقومات اللجوء والحياة الكريمة، هذا فوق الإذلال الذي يتعرضون له، وهذا فوق وضع شروط من قبل الدولة المستضيفة للاجئين وإلا يتم إرجاعهم ليقوم الحكام الظلمة بقتلهم.
الثاني: هو طردهم وعدم استقبالهم كما يحدث مع اللاجئين البورميين عندما يتم طردهم من قبل حكام اندونيسيا وماليزيا وبنغلادش.
هذا ما يبرع به حكام اليوم، أما واجب النصرة اتجاههم فهذا لا يقوم به حكام اليوم وذلك لسبب بسيط، وهو انهم لا يمثلون المسلمين وإنما يمثلون الغرب الكافر.
فواجب الحاكم المسلم عندما يعلم عن مسلم مضطهد هو النصرة بتحريك الجيوش لقتال من يضطهدون المسلمين، إن وجدت القوة، وإلا يتم استضافتهم ومعاملتهم أفضل معاملة مثل السكان الاصليين لانهم جميعا مسلمون موحدون، ريثما يتم اعداد الجيش لقتال من ظلمهم.
هذا هو الاجراء العملي اتجاه قضية اللاجئين المسلمين وهو تحريك الجيوش ومحاربة الكفار الذين آذوا المسلمين، فصلاح الدين الايوبي والحكام في عصره لم يقيموا مخيمات للاجئين الذي فروا من الصليبيين وانما تم استقبالهم كضيوف اعزاء ريثما تم اعداد القوة للقضاء على الصليبين، والمعتصم لم يقم مخيمات للمسلمين المضطهدين من قبل الروم بل حرك الجيوش وقاتل الصليبيين لصرخة امراة واحدة، وغيره من القصص تبين كيف ان حكام المسلمين عاقبوا من يعتدي على المسلمين ولم يقيموا المخيمات لاستقبالهم فقط كما يحدث اليوم.
لم يكتف حكام اليوم فقط بعدم استقبال اللاجئين وخذلانهم وعدم نصرتهم، بل انهم اقاموا سلاما مع من هجروهم مثل العلاقات التي تقيمها كثير من الحكومات مع يهود، ومثل الجهود التي يبذلها حكام تركيا لانتاج نظام سوري آخر موال لأمريكا، ومثل العلاقات التي ما زالت موجودة حتى اليوم مع حكام بورما من قبل حكومات تدعي انها اسلامية.
ان الحياة الذليلة التي يتعرض لها المسلمون جعلتهم يهاجرون الى بلاد اخوانهم، ولم يلاقوا الحياة الكريمة للاسف، وعندها هاجروا الى البلاد التي تدعي الحرية وهي بلاد اوروبا، ولكنها هي الاخرى ضاقت ذرعا بهم فتركتهم يموتون في عرض البحر، واذلتهم واهانتهم كونهم مسلمين، وبدات هذه الدول الصليبية باجراءات ضد جميع المسلمين في اوروبا حتى لا يكثر عددهم في اوروبا، وهكذا ابدت هذه الدول ايضا انيابها الحاقدة على المسلمين.
ولذلك لا حل لقضية اللاجئين المسلمين الا بازالة عروش حكام اليوم واقامة الخلافة على انقاضهم جميعا بدون استثناء، لانهم عون للكفار وليسو من جنس امة محمد وان تسموا باسمائها وتكلموا لغتها وصلوا مثل صلاتنا.
|



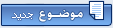




 Aug 16 2015, 12:03 PM
Aug 16 2015, 12:03 PM