******* ثوّرة شباب تحرير سوريا ******* نظراتٌ في الطائفيةِ السياسيةِ
وحقوقِ الأقلياتِ الدينيةِ
في الفكر السياسي الإسلامي
الطائفيةُ السياسيةُ هي انتماءٌ سياسيٌ لمجموعةٍ دينيةٍ أو مذهبيةٍ، بحيثُ يكوِّنُ هذا الانتماء هُوِيةً سياسيةً مميزةً و فاصلاً سلوكياً لتلك المجموعةِ عن سلوكِ الأمةِ، و عليه فالأقليةُ الدينيةُ إن بُني لها سياجٌ سياسيٌ ، وهُويةٌ سياسيةٌ، انتقلت، بفعلِ هذا الوصفِ الطارئِ، من كونِها أقليةً دينيةً ، إلى طائفةٍ سياسيةٍ.
الطائفيةُ السياسيةُ تتأسسُ في المجتمعِ بفعلِ الدستورِ و قوانينَ أساسيةٍ، إذ عندما ينصُ القانونُ على محاصصةٍ سياسيةٍ في الدولةِ ويعُطي الناسُ حقوقاً على أساسِ نظامِ كوتاتٍ طائفيٍّ، يبدأ الفرزُ المذهبيُّ والدينيُّ، ويعادُ أوتوماتيكياً تعريفُ الهويةِ و الحقوقِ و الجماعةِ و يتقلصُ الولاءُ للمجتمعِ والدولةِ لحسابِ الطائفةِ في المجتمعِ، وكلٌ يذهبُ لمن يتقوى به و يجدُ مصالحَه عندَه، هكذا يحدثُ الاستقطاب في المجتمعِ بشكلٍ سحريٍّ، فلا يتصورُ المرءُ بعدئذ نفسَه إلا في سياقِ انتمائِه الضيقِ، فإذا ما تقوت الطائفيةُ على الدولةِ، صارت الطائفةُ نفسُها هي الدولة، تديرُ أمورَها بشكلٍ مستقلٍ عن الدولةِ، و تصبحُ لها مؤسساتهُا الخاصةُ، و مستشفياتُها، و مدارسُها، وهكذا، تتفكك الدولةُ لصالحِ دويلاتِ الطائفية.
ومن هنا نستطيعُ أن نفهمَ كيف يستقيمُ ما يبدو من تعارضٍ بينَ أن من يقودُ الطائفةَ بالغالبِ غيرُ متدينٍ، أو علمانيٌّ، وبينَ أن الطائفيةَ تقومُ على المذهبِ أو الدينِ، إذ معظمُ الأحيانِ تكونُ "الطائفيةُ" السياسيةُ مكرسةً من ساسةٍ ليس لديهم التزامٌ دينيٌّ أو مذهبيٌّ بل هو موقفٌ انتهازيٌّ للحصولِ على "عصبيةٍ" كما يسميها ابن خلدون أو شعبيةٍ كما يُطلقُ عليها في عصرِنا هذا ليكونَ الانتهازيُّ السياسيُّ قادرًا على الوصولِ إلى السلطة. ونستطيعُ أن نفهمَ كيف يُستعمل رجلُ الدينِ ويُستدعى جندياً على حدودِ الطائفةِ، يستخدمُه الانتهازيون كما يستخدمون المال.
وتعيشُ المجتمعاتُ حالةً من الاحتقانِ و الظلمِ و التهميشِ، حالَ كونِ طائفةٍ اعتلت السلطةَ و خطفت الدولةَ من الجميع، هنا تتحولُ الدولةُ إلى دولةِ إرهابٍ رعبٍ، لا يُسمحُ للإنسانِ العاديِّ التنفسَ خارجَ ما تسمحُ له مصالحُ الطائفةِ المتنفذةِ وسوريا منذ عام 1970 مثالٌ كبيرٌ على ذلك.
وقد ارتبط وجود الطائفية السياسية في تاريخنا المعاصر، عقبَ هدم الخلافة ، بالاستعمار، ففي لبنانَ أسستْ الطائفيةُ السياسيةُ ، من خلالِ متصرفيةِ جبلِ لبنانِ، و قد كانت المتصرفيةُ فكرةً طائفيةً استعماريةً، و هي نظامٌ حكمٍ أقرتْه الدولةُ العثمانيةُ بضغطٍ مباشرٍ من الدولٍ الغربيةِ على رأسِها بريطانيا و فرنسا، وتم بموجَبِه فصلُ جبلِ لبنان عن سوريا لأولِ مرة. وقد جاء في أعقابِ مذابحِ 1860 وعملَ به من عام 1860 وحتى عام 1915. وقد جعلَ هذا النظامُ المناطقَ الداخليةَ في لبنان (الحاليَّ)، ذاتَ التواجدِ المعتبرِ للنصارى والدروز، تحت حكمِ متصرفٍ نصراني، عثماني غيرِ لبناني، تعينُه الدولةُ العثمانية بموافقةِ الدولِ الأوروبية. وقد استمرَ أثرُ هذا النظامِ حتى مطلعِ يومنِا هذا.
وفي العراقِ اليومَ نرى كيف بنى المستعمرُ الأمريكيُّ الطائفيةَ السياسيةَ، واستطاعَ أن يمزقَ السلمَ الأهليَّ بينَ الناسِ هناك، إذ لم تكنْ الحالةُ السياسيةُ طائفيةً قبلَ الاحتلال للعراق، فالبعثُ على كل إجرامِه لم يكنْ طائفيا، حتى أن أمناءَه الثلاثةَ الأوائلَ كانوا من الشيعةِ، وإجرامُ البعث لم يميزْ بينَ أطيافِ المجتمع، ولكن عندما قررَ الأمريكانُ تفكيكَ العراقِ عمدوا إلى المعارضةِ العراقيةِ في الخارجِ و دعموها على أساس طائفيٍّ، استمر الأمريكان في طريقِهم إلى أن أسقطوا النظامَ وجاءَ الحاكمُ المستعمرُ بريمر يؤسسُ للطائفيةِ السياسيةِ، و يوزعُ الحقائبَ على الأساسِ الطائفيِّ، فأعادت أمريكا تشكيلَ المجتمعِ العراقيِّ من خلالِ إنتاجها هُويات سياسيةٍ جديدةٍ طبعت بالدمِ وقُننت بالدستور.
إن ولادةَ الطائفيةِ السياسيةِ في بلادِنا بلا شك مرتبطةٌ بالاستعمار-كما أسلفنا- ، ولكن ثمة عوامل تساعد على تكون هذه الطائفيةِ السياسيةِ، منها مسألةُ الولاءِ للدولةِ، وفكرةُ التابعيةِ وَفقَ فكرنِا أو المواطنةِ وَفْقَ الفكرِ الغربي، إذ أن الدولَ يجبُ أن تُبنى صالحةً للإنسانِ كإنسانِ بغضِ النظرِ عن دينِه و عرقِه و منشئِه، و الشعوبُ يجبُ بناؤها معَ الدولةِ على أساسِ التابعيةِ و الولاءِ للدولةِ، فإن كان بناءُ الشعوبِ على غيرِ هذا الأساسِ أو كان ضعيفاً فتح المجالَ للطائفيةِ السياسيةِ وللانتماءات السياسيةِ الضيقةِ، وعندما تتكسرُ الدولُ أو تضعفُ تتكشفُ عما في داخلِها، فتحدِث الصراعَ و الدمار.
إن الثقافةَ المجتمعيةَ يجبُ أن تكونَ قابلةً لاستيعابِ كل مكوناتِ المجتمعِ باختلافاتها الاثنيةِ و العرقيةِ، فاختلافُ الدينِ أو المذهبِ يجبُ أن لا تسدلَ عليه الطائفيةُ السياسيةُ، ويجبُ أن يبقى يتحركُ في دائرةِ الأخذِ و الردِّ بالدليلِ و البرهان، و الأهمُ من ذلك أو يوازيه أن تطردَ الطائفيةُ من العلاقاتِ في المجتمع، فيتعاملُ الناسُ بعضُهم معَ بعضٍ بيعاً و إجارة و رهناً و قضاءً بلا تمييزٍ ولا تحريضٍ.كما لا يتهم أحدٌ أحداً سياسياً بالخيانةِ أو الإجرامِ بناءً على الهوية الطائفية.
ولكن ذلك لا يعني تجاوزَ الإسلام بحالِ، فكلُّ شيءٍ قابلٌ للتعديلِ و التكييفِ إلا الإسلام، فلا نهربُ مثلاً من مصطلح ِكافرٍ بدعوى أنه مصطلحٌ طائفيٌّ! أو نسمحُ بالزواجِ المدنيِّ بدعوى انفتاحِه على الجميعِ باختلافِ أديانِهم و مذاهبِهم! أو ندَّعي بأن غيَر المسلمِ هو أخٌ للمسلمِ، و غيرُ ذلك، لأن هذا مساسٌ بالإسلام ، والإسلامُ إنما هو خطٌ أحمرٌ لا يجوزُ تجاوزُه، فالخطابُ الإسلاميُّ يجبُ أن يكونَ ملتزِماً بالإسلامِ التزاما لا يقبلُ مداهنةً أو مجاملةً، ولكنه في الوقتِ ذاتِه خطابٌ سياسيٌّ رفيعٌ محتوٍ للآخرٍ، يستوعِبُه رعايةً بالتي هي أحسن، و ليس خطاباً استفزازياً لغير المسلم، خطاباً خشناً غليظاً ينفضُ الناسُ من حولِه.
فحينَ النظرِ في المشاكلِ السياسيةِ الحاليةِ يجبُ عزلُ الطائفيةِ السياسيةِ عندَ تحديدِ مواقفِنا منها حتى و إن كانت طائفيةً بامتياز، فلا يُقالُ إن المشكلةَ السوريةَ هي مشكلةٌ سياسيةٌ معَ العلويةِ النصيرية، وإن كان مبنى النظامِ السوريِّ طائفيٌّ بنكهاتٍ قوميةٍ خارجية!
وكذلك في لبنانَ، لا نحملُ على حزبِ اللهِ بسببِ كونِه شيعياً، فذاك محِلُّه محِلٌ آخر، محِلُّ النقاشِ بالفكرِ بين المذاهبِ، وإنما نحملُ عليه مواقفَه السياسيةَ كموسميةِ المقاومةِ عندَه، و ارتباطِه بأنظمةٍ عميلةٍ، كما نكبرُ موقفَه وهو يقاتلُ أعداءَ الأمة.
ومشكلتُنا مَعَ إيران ليست مشكلةً شيعيةً سنيةً وإن تحركَ النظامُ هناك على هذا الأساسِ، فهو طائفيٌّ ولكن نحنُ لسنا طائفيين، ومشكلتُنا معَ النظامِ السَّعوديِّ ليست هي مشكلةً مَعَ الوهابيةِ أو السلفيةِ في مقابلِ كونِ بعضِنا أشاعرةً أو ماترديةً أو متصوفةً أو شيعة، مشكلتنا معَه سياسيةٌ، فهو نظامٌ موال ٍللمستعمرِ، يطبقُ غيَر شرعِ اللهِ تعالى، وينهبُ ثرواتِ الأمة.
وكذا المشكلة مع َكلِ الأقلياتِ، حتى في الموقفِ من اليهود، نحن نميزُ بين يهوديٍ سلبَ بلادَنا وقتل أبناءَنا وبين يهوديٍّ مسالمٍ يعيشُ في بلادِ الماو ماو، بمعنى نحنُ نميزُ بين الصهويونيةِ وبين اليهوديةِ كديانة، فمشكلتُنا السياسيةُ هي معَ الصهيونيةِ وليست معَ الديانةِ اليهوديةِ، فالله تعالى لم ينهَنا عن الذين لم يقاتلونا في الدينِ ولم يظاهروا علينا أن نبرَهم وأن نقسطَ إليهم والله يحبُ المقسطين.
إن الإسلامَ عقيدةٌ روحيةٌ سياسةٌ ينبثقُ عنها نظامُ حياةٍ لكلِ انسانٍ، و الأديانُ الأخرى عقائدُ روحيةٌ وحسب، لا تملكُ أنظمةَ حياة، إنما تملكُ أحكاماً خاصةً في الأحوالِ الشخصيةِ و الشعائرِ التعبديةِ والمأكلِ و الملبسِ، و ما شاكل، فهي بطبيعتِها منفصلةٌ عن الحياةِ و السياسةِ، و تعيشُ في إطارِ علاقةِ الإنسانِ بمعبودِه و بنفسِه، فهي لا تتعدى ذلك إلى العلاقاتِ العامةِ بين الإنسانِ والإنسانِ أي لا تتعدى و لا تؤثرُ في العلاقاتِ الساسيةِ التى تُبنى عليها المجتمعاتُ، و بالنظرِ في شريعةِ الإسلامِ نجدُ الإسلامَ تركَ أصحابَ الأديانِ الأخرى على أديانِهم بلا إكراه أو تدخل، فكان هذا التركيبُ بين انفصالِ الأديانِ الأخرى عن الحياةِ و بين تغطيةِ الإسلامِ جميعَ مناحي الحياةِ معَ تركِه غيَر المسلمين وأديانَهم يجعلُ مسألةَ التعايشِ في المجتمعِ الإسلاميِّ بين مكوناتِه على اختلاف أديانِها طبيعياً سلساً لا مشكلةَ فيه مصانٌ بسياجِ التابعيةِ.
وهنا يجدرُ بنا لفت الانتباه إلى مسألةٍ هامةٍ وهي أن الأخوةَ الإسلاميةَ أو الموالاةَ للمسلمين غيرُ التابعيةِ لدارِ الإسلامِ بمفهومِها العامِ، فالتابعيةُ الإسلاميةُ هي حملُ الولاءِ للدولةِ والنظامِ، واتخاذُ دارِ الإسلامِ تحتَ ظل سلطانِ الإسلامِ دارَ إقامةٍ دائمةٍ، فهي تختلفُ اختلافاً جوهرياً عن الأخوّةِ الإسلامية. فالرابطةُ التي تربطُ الرعيةَ بالدولةِ هي التابعيةُ بالمصطلحِ الإسلاميِّ وهي ما تُعرف اليومَ بالمصطلحِ السياسيِّ الغربيِّ بالمواطنةِ، وهذه غيُر العقيدةِ الإسلاميةِ، فالتابعيةُ رابطةٌ تربطُ بين المسلمين وغيرِهم من أصحابِ المللِ الأخرى؛ للعيشِ السويِّ تحتَ نظامٍ واحدٍ يجمعُهم الكيانُ السياسيُّ الإسلاميُّ. وهذا المعنى واضحٌ في صحيفةِ المدينةِ التي كانت عهداً أو وثيقةً بين الرسولِ صلى الله عليه وسلم كقائدٍ للدولةِ الإسلاميةِ ويهود بني عوف، وقد نصت هذه الوثيقةُ أن اليهودَ هم «معَ المؤمنين أمةٌ من دونِ الناس» فهم يعيشون معَ المؤمنين تحتَ ذمةِ اللهِ ورسولِه عليه السلام ولكن هم ليسوا من المؤمنين.
والكلامُ عن التابعيةِ والطائفيةِ يستدعي بالضرورةِ الحديثَ عن أهلِ الذمةِ وحقوقِ الأقلياتِ الدينيةِ في الإسلام، فالأصلُ في أهلِ الذمةِ أن لهم مالنا من الأنصافِ، وعليهم ما علينا من الانتصافِ إلا أن هناك استثناءاتٍ قليلةً في بعضِ الحقوقِ والواجباتِ، اقتضتْها المخالفةُ في الدين.
فالإسلام إذ يفرقُ بين المسلمين والذميين في هذه الحقوقِ السياسية، ويجعلُ بعضَ الوظائفِ العامةِ مقصورةً على المسلمين وحدَهم، فذلك لأن الدولةَ الإسلامية دولةٌ مبدئيةٌ، تسيرُ وَفْقَ نظامِ الإسلام، وهذا يقتضى أن تُناطَ المناصبُ السياسيةُ، والوظائفُ العامةُ الرئيسيةُ التي تُسيِّرُ دفةَ النظامِ، بشخصياتٍ مؤمنةٍ بهذا النظامِ، متفهمةٍ لطبيعتِه، قد أُشربت قلوبُها حبَه، وإلا فقدت الدولةُ صبغتَها الإسلامية.
فكيف يتأتى إسنادُ منصبِ الإمامة لغيرِ المسلم، وهي خلافةٌ عن صاحبِ الشرعِ في حراسةِ الدينِ، وسياسةِ الدنيا به؟ وكيف يسوغُ أن يكونَ قائدُ الجيشِ كافراً، والجهادُ شُرعِ لإعلاء كلمةِ الإسلام، والذميُّ غيرُ مطالبٍ بالجهادِ أصلاً؟ فلابد أن تكونَ الوظائفُ العليا التي تقومُ على العقيدة الإسلامية، ويبرزُ فيها عنصرُ التدين، قصراً على المسلمين وحدَهم، وذلك كالإمامة، والقضاءِ، وقيادةِ الجيش، ووزارةِ التفويض ونحوِها، أما الوظائفُ الأخرى التي لا ترتكزُ على العقيدةِ الإسلامية، ولا تؤثرُ على أجهزةِ الحكمِ، فيجوزُ إسنادها إلى أهلِ الذمةِ، وقد سارَ الخلفاءُ على هذه الطريقةِ.
وهو أمرٌ طبيعيٌّ في الدولِ، فكلُّ دولةٍ مبدئيةٍ لها تصورٌ لما يجبُ أن يكونَ عليه المجتمعُ، أي لها أهدافٌ تسعى لتحقيقِها في الإنسانيةِ، فالمبادئُ الثلاثةُ الإسلامُ و الرأسماليةُ والاشتراكية، كلُ واحدٍ منها يرفضُ أن يكونَ على رأسِ دولتِه أو في وسطِه السياسيِّ رفضاً أوتوماتيكياً و قانونياً أناساً لا يؤمنون به، فهل تسمحُ الدولُ الرأسماليةُ لحزبٍ شيوعيٍ أن يخترقَ وسطها السياسي، أم هل سمعتَ بحزبٍ رأسمالي ليبراليٍ يتحركُ في بيئةٍ شيوعية، الأمرُ كذالك بالنسبةِ للإسلام ، والإسلامُ فوقَ كونِه أيدلوجيةً وطرازَ حياةٍ هو دينٌ بالأساسِ ، فأهدافُ الإسلامِ في الإنسانيةِ أهدافٌ تمتدُ من الحياةِ إلى ما بعدها،و مبدؤه يرومُ السعادةَ للبشريةِ في الدنيا و الآخرةِ، فكان من المحتمِ أن من يقومُ على دولةِ مبدأ الإسلام، في مراكزِها الحساسةِ، أناسٌ من جنسِ مبدأ الإسلامِ سياسةً و ديناً.
أما الحقوقُ العامةُ، وهي الحقوقُ التي تعتبُر مقوماتٍ لإنسانيةِ الإنسانِ كحقِه في الحاجاتِ الأساسيةِ من المأكلِ والمسكنِ والملبسِ والتطبيبِ و التعليمِ و الأمنِ فهي مكفولةٌ بدستورِ الدولةِ الإسلاميةِ لكلِ إنسانٍ. ولكلِ طائفةٍ ممارسةُ خصوصيتُها الدينية دون حيف ضمن النظام العام .
وفي خلاصةِ المقالِ نقول: إن بناةَ الدولِ يحملون صفاتِهم السياسيةَ معَهم إلى دولهِم الناشئةِ، فكيفما كانوا كانت دولهُم، لذا كان لزاماً علينا طردُ الطائفيةِ السياسيةِ عنا، فالطائفيةُ السياسيةُ إن تركت في واقعنِا ملأته دماً و ظلماً و إرهابا، وإن وجدت في خطابِنا كانت يداً علينا تُضمُ إلى يدِ المستعمرِ، و أغلقت دوننا مستقبلَنا، أو أعاقته كثيراً، هذا من جهةٍ، و من الجهةِ المقابلةِ، يجبُ أن لا نخضعَ تحتَ ضغطِ رفضِ الطائفيةِ السياسيةِ إلى تعديلاتٍ نجريها على خطابِنا يأباها المبدأ، فنميعُ خطابِنا لعيونِ الطائفيةِ السياسيةِ والاستعمار. إن الطريقَ إلى الخلافةِ يمضي على بصيرةٍ، و وعيٍّ سياسيٍّ، يحسبُ بدقةٍ لليومِ كما يحسب بدقةٍ للمستقبلِ ، و ستصلُ الأمةُ إلى غايتِها، و ستطبقُ شرعَ ربِها، بإذنِ الله، و ستقلعُ جذورَ الطائفيةِ الساسيةِ الآثمةِ، و ستقطعُ كلَّ يدٍ خارجيةٍ تحاولُ العبثَ في أمورِ الأمِة الداخليةِ، وسيُعطى كلُ واحدٍ حقَّه، مادامَ يحملُ التابعيةَ، بغضِّ النظرِ عن دينهِ أو طائفتِه أو مذهبِه أو لونِه أو غيرِ ذلك.
هذا واللهُ الموفقُ للعاملين المخلصين، اللهم لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وصلِّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، و الحمد لله رب العالمين.
أبو الهمام الخليلي ******* ثوّرة الكرامة نت *******



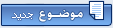


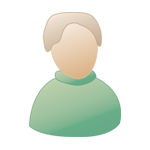


 Jun 13 2012, 03:41 PM
Jun 13 2012, 03:41 PM



