لم يغير الغرب عموما ودول أوروبا خصوصا من نظرتهم العدائية إلى الإسلام كمبدأ وطراز عيش فريد منذ زمن طويل استمر إلى عقود ممتدة مليئة بالتجارب الدامية والصراعات والتجاذبات والتقاربات المختلفة في شتى مناحي الحياة.
وكان المشهد التاريخي في هذه العلاقة يتراوح بين كر وفر، وهجوم ودفاع منذ نشأة الدولة الإسلامية الأولى في الجزيرة العربية، مرورا بالخلافة وفتوحاتها، إلى متاخمة الخلافة العثمانية لعمق أوروبا ومحاصرة فينا في القرن السادس عشر الميلادي.
والجدير بالذكر أن دولة الرسول ﷺ ودولة الخلفاء الراشدين من بعده كانت فترة قوة حقيقية وتميزت بدفع مبدئي لا مثيل له في تاريخ البشرية، فكان هم المسلمين والفتوحات الإسلامية الأول هو حمل الرسالة ونشر المبدأ وتعريف الناس بالإسلام من خلال إزالة الحواجز المادية التي كانت تقف بين الإسلام وبين الناس، فدخل الناس في الإسلام أفواجا وأصبحوا جزءاً من الأمة الإسلامية وحملوا الرسالة إلى من يليهم. واستمر هذا النهج مع بروز الحكم العضوض في الدولة الأموية والعباسية ولكن على وتيرة متناقصة، حيث بدأ اهتمام الأمراء بالحكم والسلطة يغلب شيئا فشيئا على اهتمامهم بالمبدأ وحمل رسالة الإسلام العالمية، حتى بلغ ذلك أضعف مراحله في الدولة العثمانية التي تاخمت وسط أوروبا بعد أن سيطرت على جل المناطق الشرقية منها. وهذا الضعف الفكري المبدئي يفسر التراجع والانحسار السريع للدولة العثمانية لاحقا. حيث كانت رغم تطبيقها للإسلام تعتمد على القوة العسكرية، لا على قوة المبدأ وحمله كرسالة من رب العالمين لإخراج الناس من الظلمات إلى النور.
وبناء على هذه النظرة المنبثقة عن صراع متجذر، تكرست في أوروبا استراتيجية ثابتة في التعامل مع الإسلام كعدو يجب معاداته وعدم السماح له بالتغلغل في ثقافة المجتمع، بل ومحاربة كل ما يمكن أن يجعل له موطئ قدم في البلاد وفي أذهان العباد. وكانت هذه الاستراتيجية تعتمد في أساسها على تحصين الداخل، ورص الصفوف ضد الخطر الخارجي الداهم، وذلك من خلال شيطنة الإسلام وإظهاره كعدو طامع يحتل الأرض، ويغتصب الحرائر، وينهب الثروات. ويبدو أن نهج الدولة العثمانية في بطشها بالأعداء، وإهمالها للناحية الفكرية المبدئية قد ساعد على تكريس هذه النظرة وتعميق العداء في نفوس الغربيين، الذين كانوا في صراعات مذهبية ومصلحية وعرقية شديدة بينهم، أدت إلى ضعفهم وتشرذمهم، وإلى صراعات داخلية طويلة استمرت حتى بعد منتصف القرن السابع عشر الميلادي.
وفي سنة 1648م وبعد أن دق حصار السلطان سليمان القانوني لفينا أول مرة عام 1529م ناقوس الخطر، توصل بعدها الأوروبيون إلى اتفاق فيما بينهم عرف بمعاهدة "وستفاليا" يقضي بإحلال السلام بينهم، وإنهاء الصراع المذهبي، وضرورة التصدي للخطر الخارجي الداهم، وكانت أول ثمرة لهذا الاتفاق صد حصار فينا الثاني عام 1683م في عهد السلطان محمد الرابع. وكان هذا بمثابة بداية تراجع نفوذ الدولة العثمانية وانحسارها عن أوروبا. فبدأ بذلك الأوروبيون بتقوية عنصر آخر في استراتيجيتهم تجاه الإسلام وهو عنصر الصراع الخارجي، أي نقل الصراع إلى مناطق نفوذ المسلمين وبلادهم ومحاربتهم فيها، وذلك عن طريق اعتماد وسائل وأساليب عديدة منها حبك المؤامرات وإثارة النعرات الداخلية التي تمكنهم من الدخول إلى مناطق الدولة بحجة حماية الأقليات وضمان الامتيازات، وبقوا على هذا الحال حتى استطاعوا القضاء على الدولة العثمانية آخر معاقل المسلمين في بداية القرن العشرين بعيد الحرب العالمية الأولى، ثم عمدوا إلى تفتيت بلاد المسلمين وتقسيمها إلى كنتونات من أجل استعمارها مباشرة ونهب خيراتها، وبانتهاء فترة الاستعمار المباشر عينوا نواطير من أعوانهم على الكيانات الوظيفية التي أوجدوها وسلطوهم على رقاب العباد من أجل تحقيق مصالحهم. وهذا ما عليه الوضع اليوم. لم يتغير فيه الشيء الكثير رغم نشوء أفكار جديدة واندثار أخرى، وسقوط دول وحضارات وتقدم أخرى في مراكز متقدمة من الموقف الدولي.
ومن خلال هذا السرد التاريخي المختصر، يتضح لنا أن عداء الغرب للإسلام ككيان سياسي متجذر وعميق، وعليه فإن نظرتهم واستراتيجياتهم للتعامل مع المسلمين بشكل عام لم تتغير، وليس من السهل عليهم تغييرها، لأن الإسلام بات بعد انهيار المعسكر الشرقي هو المنافس المبدئي الوحيد للنظام الرأسمالي، وخطره من وجهة نظرهم يزداد يوما بعد يوم.
أما الذي يتغير فهو الوسائل والأساليب والسياسات المرحلية تبعا لتغير الأوضاع السياسية والاقتصادية واختلاف الموازين في القوى الدولية.
فمثلا: مع تزايد عدد المسلمين في أوروبا منذ خمسينات القرن المنصرم جراء النهضة الصناعية، والتسارع المستمر في الزيادة، اعتمدت معظم دول أوروبا سياسة الشيطنة والضغط على المسلمين الذين يعيشون في كنفها، لدرء خطر الإسلام. فأوعزت إلى وسائل صناعة الرأي العام أن تتناول وباستمرار مواضيع من شأنها أن تشوه الإسلام في ذهن الأوروبي وتجعل من عدائه أمرا بديهيا، مستغلة جهل أوروبا بالإسلام وعداءها التاريخي له، وانشغال الغربيين بالحريات ومتع الدنيا ومشكلاتها، وإشارة إلى أنه سبب تخلف بلاد المسلمين. وهي تستعمل هذا الرأي الذي تصنعه للضغط على رعاياها من المسلمين، فتجبرهم "حسب ظنها" إلى الإنحياز إلى ثقافتها وحضارتها بعد أن تخيرهم بطريقة أو أخرى بين الرضا والبقاء أو الرحيل والعودة إلى العالم الثالث حيث القلاقل وانعدام الأمن.
لكن هذه السياسة أثبتت مع مرور الزمن وتطور وسائل الاتصال والمواصلات عقمها، بل وأتت بنتائج مغايرة في كثير من المناطق، أدت إلى تداعيات يصعب السيطرة عليها. كخلق تيارات سياسية تؤدي إلى فتح صراع مفتوح في المجتمع بين مؤيد ومعارض، وقلاقل قد لا تتمكن الحكومات من كتمها، أو قد تكون أداة ضغط في يد المعارضة تضخم فشلها وتعقيداتها وتستعملها لأهداف سياسية.
وبالنظر إلى الكساد الاقتصادي الذي ضرب العالم ومنه أوروبا مؤخرا.
وبالنظر إلى ارتفاع الأصوات التي تنبه من مغبة التغاضي عن خطر النقص في الأيدي العاملة الدافعة للضرائب، وتزايد عدد كبار السن والمعونين بالنسبة للعاملين، وخطر نقص النمو السكاني بشكل عام.
وبالنظر إلى تفاقم مشكلة اللجوء واللاجئين جراء الحروب في مناطق النفوذ الغربي، وصراع الدول الرأسمالية فيما بينها على الغنائم، وصراعها مع الشعوب التي تتوق إلى التحرر من الاستعمار.
وبالنظر إلى تراجع ملحوظ لشعبية ودور أمريكا في إدارة الصراع في المناطق المهمة من العالم، وبخاصة القريبة منها من أوروبا.
بالنظر إلى ذلك كله، يبدو أن بعض حكومات أوروبا وبالذات ألمانيا، رأت أن الوقت قد حان لبعض التغيير في السياسة المرحلية للتعامل مع رعاياها من المسلمين. فأوعزت إلى وسائل الإعلام وصناع الرأي من المفكرين بتخفيف حدة الهجوم على الإسلام والمسلمين، ومهاجمة التيار الذي يطالب بطردهم والسخرية منه وبيان عدم جدواه، ومحاولة إبراز الدور الإنساني لأوروبا، وطرح فكرة قبول المسلمين في المجتمع مع الإصرار على الحد الأدنى من الاندماج. والتصريح بأن الإسلام جزء من أوروبا. والتركيز على مبدأ المواطنة بعيدا عن العرق والدين.
ومع تفعيل هذه السياسة قامت الحكومة بفتح الباب للاجئين "وخاصة أهل سوريا" ومكنتهم من الدخول إلى أوروبا، وأعدت الميزانيات الباهظة لتحقيق أهداف عديدة منها:
أولا: رفد الاقتصاد الألماني وتسريع عجلة النمو عن طريق الاستفادة من خبرات اللاجئين وتطلعهم إلى الانضباط بالعمل بسرعة. فبحسب الإحصائيات الرسمية: 40% من هؤلاء مؤهلون تأهيلاً عالياً، ومعظمهم يتوق إلى العمل وبدء حياة طبيعية آمنة مع أسرته. ومستعد للاندماج وحتى الذوبان في المجتمع بدون فرض قيود مسبقة.
وقد يقول قائل: إن بلداً صناعياً ناجحاً مثل ألمانيا يستطيع أن يفتح باب الهجرة للخبرات التي يحتاجها ويسد الشاغر المتزايد في الوظائف الخالية التي لا يريد كثير من الألمان ملأها، أو لا يوجد من يشغلها في ألمانيا. ولا حاجة ملحة له لاستعمال ورقة اللجوء.
ولكن هذا عين ما جرّبته ألمانيا في نهاية القرن الماضي وبداية القرن الحالي وأخفقت لأسباب عديدة أهمها اللغة، والتكلفة الباهظة، وشروط العيش والعمل، واختلاف الثقافات، وعدم قدرة النظام على التعامل مع الوافدين وفرض قيم الاندماج عليهم كما يريد. فعادوا إلى بلادهم أو اتجه كثير منهم إلى بلاد أخرى مثل كندا وأستراليا.
ثم إن هذا العمل لا يصب في حل المشكلات الأخرى المرتبطة مع البطالة، فالاعتماد على اللاجئين يصب في حلول لمشكلة البطالة، ومشكلة تزايد أعداد المعمرين ونقص النمو السكاني، بتكلفة قليلة نسبيا، بالإضافة إلى تحقيق مصالح سياسية أخرى، وهذا الحل يبدو في نظر المستشارة ميركل حلا مثاليا.
ثانيا: تحقيق مصالح سياسية على المدى الطويل في مناطق الصراع القريبة من أوروبا، وذلك عن طريق تسويق السياسة الأوروبية الإنسانية وتفعيلها لحقوق الإنسان وعطفها على المهجرين، وفتح أبوابها لهم في حين لم يسعفهم الأقربون! وتلميع صورة أوروبا في ذهن الناس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خصوصا بعد أحداث باريس وشبيهاتها، وبعد العزف العالمي المستمر على وتر المسلمين الذين يلتحقون بصفوف التنظيمات الجهادية، وذلك طمعا في استثمار هذه السياسة الناعمة فيما بعد، عندما تستقر هذه المناطق وتبدأ فيها عملية إعادة الإعمار والتنمية، ولإيجاد
موطئ قدم لها في هذه المناطق تستطيع أن تحقق من خلاله أكبر قدر من مصالحها.
وثالثا: وهو ربما الأهم بالنسبة لألمانيا: إن هذه السياسة تعتبر خطوة إلى الأمام في محاولات الانعتاق التدريجي من نفوذ أمريكا الدولة الأولى في العالم والانفكاك من القيود الدولية التي تفرضها على السياسات الأوروبية وخاصة سياسة ألمانيا. ومحاولة فرض إرادتها على دول أوروبا الأخرى، لتعلن مركزها كقوة عالمية فاعلة، ليس فقط على مستوى أوروبا، وتستطلع ردود فعل الدول الأخرى الفاعلة في السياسة العالمية مثل أمريكا وبريطانيا، وإمكانية التنسيق مع دول الاتحاد الأوروبي على أسس مستقبلية جديدة تقويها في مواجهة العنجهية الأمريكية لتعزيز نصيبها من ثروات العالم وموارده.
وتعزز هذه النقطة أمورٌ عديدة سابقة مثل فضح قضايا التجسس الأمريكي على أوروبا، وكشف التعاون بين المخابرات الألمانية ووكالة الأمن القومي الأمريكية وجعله قضية ومبرراً لإعادة هيكلة جهاز المخابرات الألماني للحد من سطوة أمريكا فيه. وكذلك دور ألمانيا في أوكرانيا وجذبها العلني للسياسيين الأوكرانيين إلى باحة الاتحاد الأوروبي، على خلاف ما تريده أمريكا لأوكرانيا. وتحد قوانين الاتحاد الأوروبي في مسائل الهجرة وفرض السياسة الجديدة في أوروبا مع اعتراض دول شرق أوروبية سهلت أمريكا دخولها الاتحاد لتكون عائقا في بروزه كقوة عظمى. وكذلك وقوفها مع التصور الأوروبي في حل قضايا الشرق الأوسط وبخاصة سوريا.
الأوضاع تتغير والعالم يتغير والسياسة تتغير والله وحده أعلم بما تخبئه الأيام. ولكن وفي غمرة متابعة الأحداث وتحليلها والدخول في فسيفساء الأعمال السياسية ومآلاتها، علينا ألا ننسى الصورة الإجمالية ومراعاة عدم الخروج عن إطارها العام، وألا ننخدع بالسياسات المرحلية ونعتبرها تغيرات جذرية تبنى على أساسها استراتيجيات.
كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
د. محمد عقرباوي
16 من ذي الحجة 1436
الموافق 2015/09/30م



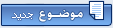


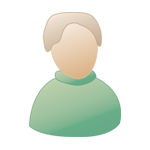


 Sep 30 2015, 05:25 AM
Sep 30 2015, 05:25 AM



