وقفة مع الرأسـمالية والعلمانيةتستحوذ الحضارة الغربية على العالم، فبعد أن نشأت في أوروبا في القرن الثامن عشر، استطاعت أن تزيح الحضارة الإسلامية من مركز الصدارة، ثم لاحقتها في بلاد المسلمين حتى حلّت محلّها بعد النصر العسكري الذي حققه الغرب على دولة الخلافة العثمانية في الحرب العالمية الأولى، عن طريق سيطرته الكاملة على البلاد والعباد. فأخذت زعيمتا الغرب آنذاك، بريطانيا وفرنسا، تخططان للقضاء على الحضارة الإسلامية، وتجلياتها في حياة المسلمين، ثم لمنع عودة الحضارة الإسلامية إلى الوجود تتزعمهما الآن في ذلك أميركا. وكانت الفكرة الاشتراكية وطروحاتها العالمية تصفية الاستعمار، والسلم العالمي، ووحدة الطبقة العاملة، أول تحد جدي يجابه حضارة الغرب، سيما بعد أن تركز في منظومة دول المعسكر الاشتراكي بزعامة روسيا. ولكن الاشتراكية لم تستطع أن تركّز حضارة خاصة بها، وواصل الناس تسيير شؤونهم بحسب معتقداتهم الدينية، إلاّ ما كان منها متصلاً بالدولة، التي كانت تسيّره بحسب الفكرة الاشتراكية التقدمية. وعند انهيار الاشتراكية، وتفتت الاتحاد السوفييتي في بداية العقد الحالي، سقط التحدي الجدي الوحيد للرأسمالية وللحضارة الغربية، وبذلك تفرّدت الحضارة الغربية وطروحاتها الفكرية كالديموقراطية والليبرالية ونظام الحريات، بالهيمنة على العالم. ولا يوجد الآن حضارة فيها قابلية التحدي وحتى الانتصار على الحضارة الغربية سوى حضارة الإسلام، وهي ما تزال مشاريع في أذهان المسلمين، أو أهدافاً تعمل لتحقيقها أحزاب وجماعات. فهل هذا الانتصار الكاسح لحضارة الغرب في العالم ناتج عن صحة أيديولوجية الغرب؟ أم أنه انتصار مؤقت سببه التفوق الغربي في مجال التكنولوجيا، والعلوم والمكتشفات؟ سنحاول في هذه المقالة الإجابة عن ذلك .
إن الرأسمالية هي نظام اقتصادي منبثق عن فكرة كلية عن الحياة والكون والإنسان، ولإدراك واقع الرأسمالية والحكم عليها، لا بدّ من محاكمة الفكرة التي انبثقت عنها ألا وهي العلمانية والتي تعني فصل الدين عن الحياة. وهذه العقيدة كان منبتها الغرب وعلى وجه الخصوص أوروبا ويكفي هذه الفكرة الأساسية فساداً ونقصاناً أنها لم تكن نتاج إعمال العقل في واقع الكون والإنسان والحياة وعن علاقتهم بما قبلهم وما بعدهم، وإن كانت تقرر أحكاماً بخصوص هذه المدركات وما يربطها بما قبلها وما بعدها، إلا أنّ هذه الأحكام التي تتعلق بمبدأ الإنسان والحياة والكون كان ناتجاً عن ردة فعل للحياة العصيبة التي عاشها الغربيون في القرون الوسطى والتي تجسدت في الصراع بين الكنيسة والعلم، وبين رجال الدين ـ الذين يمثلون الله على الأرض ـ ورجال الفكر الذين يمثلون الحياة العلمية المرتبطة بالنواحي المادية من الحياة. ولم يكن العقل هو الحكم النهائي في حسم هذا الصراع بشكل متجرد من كل خلفية بل إن الدماء التي سالت والرعب الذي ساد وحالة الجبروت والطغيان التي ظهرت عليها الكنيسة ـ التي كانت تمثل الدين ـ وحالة القرف والامتعاض والقهر التي أدت إلى ثورة أهل العلم وأهل الفكر فحسمت القضية بحل وسط لعدم قدرة أحد الطرفين على إلغاء الآخر. وهو الاعتراف بالكنيسة ـ الدين ـ مع فصلها عن الحياة والتي خرجوها على مذهب دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، أي الاعتراف بالمتناقضات مع استحالة اجتماعها، فعندهم أنَّ الدين هو ضد العلم، وأن الإيمان يتعارض مع العقل إذ أن الأول يتعلق بالمغيب وهو ما لا يمكن إدراكه ـ والثاني متعلق بالحس وبالواقع الملموس أو المحسوس، ولهذا جعلوا لكلٍ منهما مجاله، فالدين علاقة بين الإنسان وخالقه، ومجاله الكنيسة، والعلم ينظم كل العلائق الأخرى، ومجاله الحياة على سعتها.
ومن هنا جاء التضارب في هذا المعتقد الذي يحتوي المتناقضات بحسب مفاهيمهم عن العلم والدين والعقل الإيمان. ولذلك كان من المحال التسليم بالعلمانية أي عقيدة فصل الدين عن الحياة فهي ليست مبنية على العقل وإنما على الحل الوسط فهي تتضمن التسليم بالدين أي الاعتراف بالخالق وبيوم الحساب، وكذلك بالحياة المادية العلمية التي هي محصلة العقل. وهكذا نجد أن هذه العقيدة ينقض أولها آخرها. لذلك كان لا بد من ردها وإنكارها.
أن العقل هو الأداة الحاكمة على الوقائع وهو ما يتميز به الإنسان عن بقية المدركات. والناظر في واقع المدركات التي تشمل الكون والإنسان والحياة يجد أنها تستند في وجودها إلى غيرها إذ أنها محدودة فهي عاجزة وناقصة ومحتاجة وبالتالي فهي ليست قائمة بذاتها بل تحتاج لموجد أزلي واجب الوجود تستند في وجودها إليه وتخضع لنظامه وسننه. وللتدليل على هذه العقيدة هناك ما لا يمكن حصره من الأدلة العقلية والكونية التي بثها الله في أنحاء مخلوقاته والتي تقطع بحتمية ارتباط الكون والإنسان والحياة بخالق خلقها جميعها.
ومن هنا نجد أن العقل هو الأداة الموصلة للإيمان وأن أصل الدين هو محصلة نظر العقل في واقع الكون والحياة. ومن هنا يتبين أيضاً بطلان تعميم قاعدة أن الدين يتناقض مع العقل إذ إنه إن انطبق على العقيدة النصرانية، التي يعترف أصحابها أنفسهم بعدم قدرة العقل على إثبات عقيدتهم وأن اعتناقها يكون من جراء إلقاء الرب نعمة الإيمان في القلب فالدين عندهم هو شيء تشعره ولا تعقله. إلاّ أنه لا ينطبق على الإسلام الذي يجعل العقل هو الحكم على صحة وصدق عقيدته، والموصل إليها.
فالعقيدة الإسلامية قائمة على أركان هي: الإيمان بوجود الخالق المدبر، والإيمان بأن القرآن من عند الله، والإيمان بمحمد خاتم الأنبياء والرسل وبأن ما جاء به هو من عند الله. وهذه الأركان هي جماع العقيدة الإسلامية وهي ما يحكم العقل المجرد عن الهوى وعن أية خلفية سوى بديهيات العقل بصحتها ومطابقتها للواقع.
ومن هنا نجد أن الرأسمالية مبنية على عقيدة منهارة أصلاً، ولا تصلح لأن تكون القاعدة الفكرية التي يبني الإنسان عليها حياته، فالتناقض والتضارب صارخ في أصلها وما بني على باطل فهو باطل، ولذلك كانت أنظمتها للحياة باطلة، ولا تحقق سعادة البشر.
ولعل التفصيل هنا يعطي نماذج واضحة على عدم صلاحية الرأسمالية للإنسان أي إنسان لأنها لا توافق الفطرة ولا تقنع العقل فتملأ النفس اضطراباً والقلب همّـاً والحياة بؤساً.
والإنسان وما في فطرته من غرائز وحاجات عضوية (وهي الطاقة الحيوية التي تحتاج إلى الإشباع) قد مسختها الرأسمالية، إذ أخرجت الإنسان من تحت سلطان الله وتدبيره، مع اعترافها الضمني بوجوده، فأنكرت وجود علاقة تدبير من الخالق تضبط حياة الإنسان لإصلاح حياته فاعترفت لِلّه بالخلق، ولكن لا أمر له بيننا، ولا حكم له على أفعالنا، فالله له الخلق فقط وليس الخلق والأمر، كما يقول تعالى: (ألا له الخلق والأمر). فأقرت حاجة الإنسان إلى خالق يخلقه، وأنكرت حاجته إلى مدبّر، وهي ما تنطق بها فطرته ما اضطر الإنسان للاعتماد على ذاته ليعرف مصلحته ومنفعته، فحولته إلى وحش كلُّ همه هو إشباع أكبر قدر من اللذة الحسية الآنية، ولذلك كانت الأثرة والأنانية محور تفكيره. فعلى مقدار تحقيق النفعية الأنانية على قدر ما ينسجم الإنسان مع الرأسمالية، وفي هذا تشويه لفطرة الإنسان، الذي لديه غرائز تعتبر من مقوماته كإنسان وهي خارج دائرة الأنا والتي إن لم يتم إشباعها أدى ذلك إلى شقاء الإنسان وتعاسته.
وهناك غرائز يضحي الإنسان بنفسه من أجل إشباعها، فهو يبذل نفسه رخيصة في سبيل إعلاء راية دينه أو نصر مبدئه، وهذه من مظاهر غريزة التدين، وهو يضحي بماله وبراحته وربما بنفسه من أجل أولاده، وهذه من مظاهر غريزة النوع، ولهذا فإن الإنسان إذا جعل نفسه مركز الدائرة التي يدور ضمنها، فإنه يشقى، والأصل في المبدأ الصحيح أن يحقق سعادة الناس.
هذا على الصعيد الفردي، أما على الصعيد العالمي، فهي تجعل العلاقات بين الدول تتحكم فيها النفعية، وتسلط الأقوياء على الضعفاء ولا تجعل للضعفاء مكاناً في الأرض، إذ لا أحد يفكر فيهم ولا في قضاء حوائجهم، فهم عالة على البشر، والأولى أن يموتوا، هذه نظرة الرأسمالية اللاإنسانية، وما الاستعمار إلا المرحلة النهائية من الرأسمالية، إذ تتسابق الدول القوية على استضعاف من كان به ضعف، من أجل استغلاله وامتصاص دمه، ومن هنا تنشأ المنازعات بين الدول الاستعمارية، وبالتالي الحروب المدمرة. وباستعراض الحروب في القرنين الماضيين، نجد أن سببها التكالب على المصالح المادية، والتنازع على خيرات الشعوب.
وفي السنوات الأخيرة، ظهرت بدع العولمة والخصخصة، التي تجعل للأقوياء حق استغلال الطاقات البشرية والفنية والموارد الطبيعية، والأسواق التجارية في كل مكان في العالم، وذلك بشكل مسموح به قانونياً، وتؤكده الاتفاقات الدولية مثل منظمة التجارة العالمية، ويعمل على حماية هذه الاستثمارات بقوة السلاح، حتى لا يخطر ببال أحد أن ينقلب عليها، ويطالب بترحيلها أو بإضعاف سطوتها.
أن الرأسمالية بنيت على جرفٍ هارٍ فهي أصلاً وفصلاً باطلة ولا تصلح للإنسان كونها لا تنسجم مع فطرة البشر فتطبيقها عليهم يخلق المشاكل والأزمات المتتالية وما أن يتم ترقيع مشكلة حتى تظهر أزمة جديدة فأصبح الحل الوحيد بعد أن اتسع الفتق على الراتق هو إسقاط الرأسمالية كنظام والعلمانية كعقيدة من حسابات البشر لأنها لا تصلح سوى لتدمير البشرية والإجهاز عليها. ومن الغريب، أن يتشدق أناس بانتصار الرأسمالية على ما عداها، وبأن التاريخ قد توقف، لعدم وجود من ينافس الرأسمالية، وذلك صحيح بالنسبة للاشتراكية، أما بالنسبة للإسلام، فهو لم يستقر الآن في دولة تحمله للعالم، وهو عائد إلى الحياة الدولية بقوة، وعن قريب، وعندها سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
إنّ العلمانية هي الجرثومة التي تصيب بمرض اسمه الرأسمالية يُعنى بالقضاء على الإنسان كإنسان. فهل بعد هذا كله يصح القول بأن علينا أن نأخذ من الغرب الكافر ما نصلح به حالنا من علمانية ورأسمالية، وهي كفر محض تهبط بالإنسان إلى أدنى مراتب الانحطاط؟!
هل نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير وهو الإسلام الذي ارتضاه الله لعباده والذي لا يصلح البشر إلا به. وهو القائل: (يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم) ويقول: (ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا )@ فالرأسمالية والعلمانية هي الكفر الذي يحط من قدر الإنسان بل ويخرجه عن إنسانيته.
والإسلام هو الذي يقرّر ما في فطرة الإنسان من ضعف وعجز واحتياج، ليس فقط إلى موجد أوجده من عدم، وإنما إلى من يدبر له أمر تنظيم إشباع طاقاته الحيوية على وجه بضمن له الهناءة والسعادة، والإشباع الصحيح .
أبو بلال المقدسي



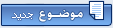


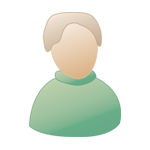


 Sep 14 2018, 08:54 PM
Sep 14 2018, 08:54 PM



